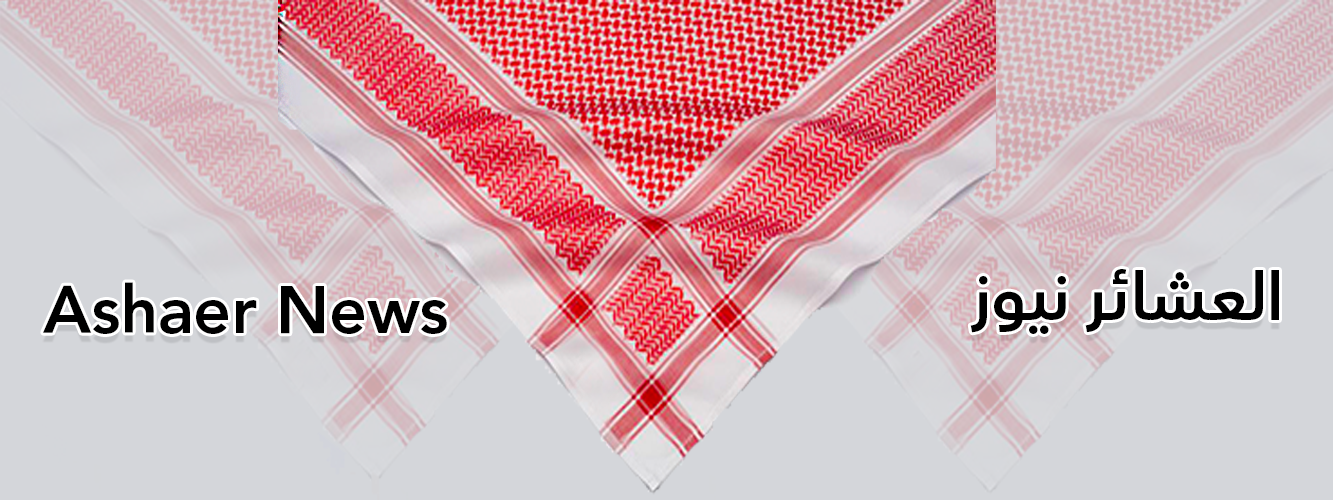الإسلام السياسي

كتب احمد عدنان
حدثان لافتان من العراق، الأول مطالبة منشد عصائب أهل الحق مهدي العبودي بإزالة تمثال الخليفة العباسي وباني مدينة بغداد “أبو جعفر المنصور”، وأكد على ذلك المحلل السياسي جمعة العطواني الذي دعا إلى إزالة التمثال المذكور، معتبراً أنه “صنم جدلي ويستفز بعض العراقيين”. أما الحدث الثاني فهو مطالبة الزعيم المعمم مقتدى الصدر باعتماد “عيد الغدير” عطلة وطنية في العراق بذريعة “درء الطائفية وتعزيز التعايش السلمي” واعتماد البرلمان العراقي لمطلب زعيم التيار الصدري.
أما في لبنان، فقام الثنائي الشيعي (“حزب الله” خصوصاً) بتعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية المرة الثالثة توالياً، الأولى بعد انتهاء ولاية الرئيس إميل لحود، والثانية بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان، والثالثة والراهنة بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون. وتزامن التعطيل الثالث هذه المرة، مع استفراد ميليشيا “حزب الله” بإدخال البلاد في حرب غزة رغماً عن إرادة الدولة وأهلها بداية من 8 أكتوبر وفقاً لتصريح علني ورسمي للأمين العام للميليشيا.
وكل هذه الأحداث سواء في العراق أو في لبنان ما هي إلا رأس جبل الجليد، فالعراق يعيش منذ 2006 – بداية من حكم رئيس الوزراء نوري المالكي بالتحديد – حكم الميليشيات المتأيرنة، وشهدت هذه الحقبة أسوأ الممارسات الطائفية مطلقاً، فضلاً عن استشراء الفساد وانعدام الأمن وغياب الكفاءة والرشد في إدارة الدولة بمواردها ومؤسساتها، ويستثنى في تلك الحقبة فترة الرئيس مصطفى الكاظمي. وفي لبنان أدى إطباق الثنائي الشيعي (“حزب الله” بالذات) على القرار السياسي في الدولة بداية من 2011 تقريباً إلى أفدح انهيار مالي واقتصادي في تاريخ البلاد بدأ في سنة 2019، وما زال يتعاظم، فضلاً عن سطوة الفقر وتراجع مؤشرات الأمن وانعدام معدلات النمو.
خرج الشارع العراقي محتجاً ومندداً “إيران برا برا”، وتظاهر اللبنانيون في 2019 ثم أسقطوا التحالف السياسي الذي يقوده الثنائي الشيعي في انتخابات 2022، ففي 19 مايو/ أيار من ذلك العام أقر السيد حسن نصر الله بخسارة الغالبية النيابية، ورغم كل ذلك لم يتغير شيء في لبنان أو العراق إلا للأسوأ.
لقد أضاع الإسلام السياسي الشيعي حاضر العراق وماضيه، كما أضاع الإسلام السياسي الشيعي رسالة لبنان وأمواله واستقراره واعتداله وانفتاحه واتصاله بالعالم، وما فعله الحوثيون في اليمن ونظراؤهم في سوريا ليس بعيداً وربما هو أفظع وأبشع.
باختصار شديد يعيش العالم العربي أزمة الإسلام السياسي الشيعي، وأبرز ملامحها:
وجود أحزاب وميليشيات مسلحة تعلن ولاءها الديني والسياسي لإيران، وتقدم الطائفة والمذهب على هويتيها الوطنية والعربية.
أدينت هذه الأحزاب في غير دولة بجرائم الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال والتجسس والاغتيالات وغيرها من الجرائم.
كان لهذه الميليشيات الأثر السلبي الخطير على الدول التي تتواجد فيها، فأغلبها فتك به الانهيار والتفكك والتعطيل.
ثبت أن هذه الأحزاب والميليشيات لها أنشطة معادية ضد المحيطين العربي والخليجي.
اقترفت هذه الميليشيات جرائم طائفية مغطاة بخطاب ديني متطرف، وبعد أن تشبعت من استهداف محيطها وحاضرها اتجهت إلى الانتقام من التاريخ.
تقوم هذه الميليشيات والأحزاب في بعض الدول بتبشير طائفي من جهة، وبتغير التركيبة الديموغرافية من خلال التهجير والهجرة من جهة أخرى.
وأدت هذه الممارسات وغيرها إلى تهديد السلم الأهلي والوحدة الوطنية في غير دولة عربية، وإن كان حاضر تلك الدول صعباً، ففي ظل استمرار هذه الميليشيات – من دون أي بوادر ملموسة لمعالجتها أو مواجهتها – يبدو المستقبل أصعب.
في المقلب الآخر، واجه السنة بداية من أحداث سبتمبر/ أيلول 2001 ثم حكم جماعة “الإخوان المسلمين” لمصر بعد ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 أزمتهم مع الإسلام السياسي السني بشجاعة وبجذرية، إذ أدركت أنظمة الحكم العربية “السنية” ومن أمامها النخبة المثقفة أن وجود الإسلام السياسي الذي ينتسب الى السنة زوراً وبهتاناً – وليس ممارساته فقط – هو التهديد الأكبر لفكرة الدولة ومفهومها ومشروعها، وأن هذه النسخة المشوهة من الإسلام ستدمر قيمة المواطنة في الداخل وستنسف فكرة التعايش السلمي في الداخل والخارج، وستقضي على صورة الإسلام السمحة والحضارية، فتم إعلان حرب لا هوادة فيها ضد تنظيم “القاعدة” وضد جماعة الإخوان وضد تنظيم “داعش”، وجاءت النتائج إيجابية وناجحة إلى حد كبير، ومن أسباب ذلك التضامن والتناغم مع المجتمع الدولي الذي دعم وشارك، وما كان لتلك الجهود أن تثمر لولا اعتراف السنة أنفسهم بالخلل والأزمة.
لكن على الصعيد الشيعي يبدو الوضع مختلفاً، فإن كان السنة محظوظين باستيعاب دولهم المركزية وعلى رأسها السعودية ومصر خطورة الإسلام السياسي والإرهاب، كانت الدولة المركزية الشيعية (إيران) هي المؤسسة والراعية للميليشيات الإرهابية المتأيرنة في كل مكان. وكان السنة محظوظين بالدعم الدولي في مواجهة الإرهاب، وفي المقابل هناك مجاملات استثنائية من المجتمع الدولي لإيران وميليشياتها، وأخيراً كانت النخبة السنية المثقفة في أغلبها أسبق في رفض فكر التطرف والتحذير منه، أما صوت الاعتدال في النخبة المثقفة الشيعية فكان خافتاً ومستضعفاً، وربما من أسباب ذلك أنهم يصدحون بالحق في بيئة معادية ومناخات انتحارية.
هذه دعوة لتكاتف عربي وإسلامي ودولي، يعترف أولاً بأن وجود الإسلام السياسي الشيعي بحد ذاته أزمة خطيرة، ثم يعمل – بالشراكة مع النخبة الشيعية المثقفة والعلمانية – على محاولة إيجاد الحلول التي تمنع المتأثرين بالإسلام الشيعي الإيراني من قتل أوطانهم وشعوبهم العربية، وبالتالي محاولة منعهم من قتل أنفسهم وأتباعهم من حيث لا يشعرون، أما إذا أصروا على البغي والعدوان فلا مفر من إجراءات أكثر صرامة.
أي استهداف للشيعة كطائفة مرفوض ومدان ومستنكر، لكن المواجهة السياسية الشاملة للميليشيات المتأيرنة أمر لا بد منه، وهذه ليست مواجهة ضد الشيعة كما أن محاربة “داعش” و”القاعدة” والإخوان لم تكن حرباً على السنة، لكن العنوان العريض للمواجهة السياسية هو استكمال مواجهة الإسلام السياسي، فتلك مواجهة بدأت ولم يجرِ إتمامها.
استمرار الميليشيات المتأيرنة هو مقتل للأوطان العربية، واستمرار تغول الإسلام السياسي الشيعي سيحيي بالضرورة الإسلام السياسي السني من جديد، فتغرق المنطقة تماماً بين إرهابين وتطرفين يبدوان ظاهراً في بعض الأحيان متخاصمين لكنهما حقيقة متكافلان، والدليل على ذلك العلاقة المثبتة بين إيران وبين الإخوان و”القاعدة” و”حماس”، {وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ ۙ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ}.